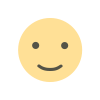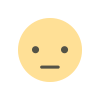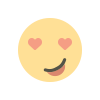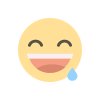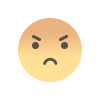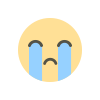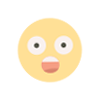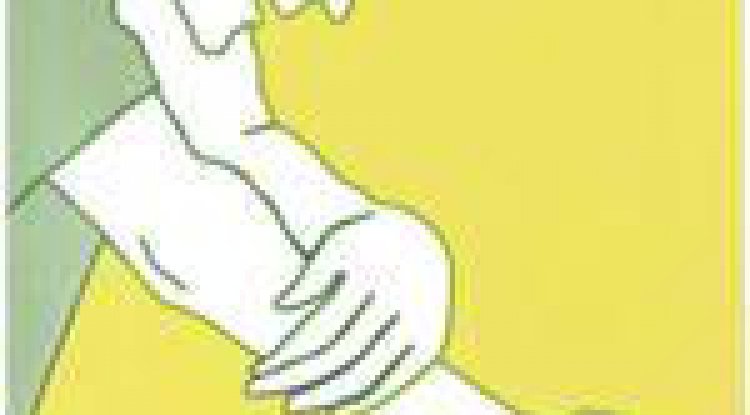القاعدة الأساسية الرابعة المشقة تجلب التيسير
القواعد الفقهية الأساسية

والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وفي لفظ " رُفع عن أمتي " رواه (بن ماجة عن ابن عباس، وقال عليه الصلاة والسلام: " بُعثت بالحنيفية السمحة" أي السهلة، أخرجه الإمام أحمد، وقال أيضاً: "إنما بُعثتم مُيَشرين، ولم تبعثوا مُعَسِّرين " رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة وغيره، وقال أيضاً: " إن دين الله يسر ثلاثاً" رواه الإمام أحمد وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما خُير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً " رواه البخاري ومسلم.
والأحاديث في ذلك كثيرة.
ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي: 1 - ألا تكون مصادمة لنص شرعي، فإذا صادمت نصاً روعي دونها.
2 - أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، واكتساب المعيشة.
3 - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج.
4 - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة.
فهذه المشقات الأربع: لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع.
وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب، ولذلك قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
وقال السيوطي: "فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه ".
التطبيقات إن أسباب التخفيف في المشقة التي تجلب التيسير سبعة أنواع، نذكر كل نوع وبعض الأمثلة له.
أولاً السفر، وتيسيراته كثيرة، منها: 1 - جواز تحميل الشهادة للغير في غير حد ولا قود.
(الزرقا ص 157) .
2 - جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر ولا قاضي ثمة.
(الزرقا ص 157) .
3 - جواز فسخ الإجارة بعذر السفر.
(الزرقا ص 157) .
4 - جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر.
(الزرقا ص 158) .
5 - جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة.
(الزرقا ص 158) .
6 - جواز كتابة القاضى إلى القاضي في بلد المدعى عليه شهادة شهود المدعي عنده.
(الزرقا ص 158) .
7 - جواز الإفطار في رمضان للمسافر.
(الدعاس ص 31، اللحجي ص 37) .
8 - سقوط صلاة الجمعة عن المسافر.
(الدعاس ص 31، اللحجي ص 38) .
9 - قلة عدالة الشهود وقبول الأمثل فالأمثل في السفر.
(الدعاس ص 31) .
10 - جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر.
(اللحجي ص 37) .
11 - جواز المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة في السفر.
(اللحجي ص 37) .
12 - جواز أكل الميتة للضرورة في السفر.
(اللحجي ص 38) .
13 - جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
(اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 447) .
14 - جواز التنفل على الدابة في السفر.
(اللحجي ص 38) .
15 - جواز التيمم للصلاة في السفر عند فقد الماء.
(اللحجي ص 38، الفتوحي 4 / 446) ثانياً: المرض، وتيسيراته كثيرة، منها: 1 - جواز تحميل الشهادة، كما مر في السفر.
(الزرقا ص 158) .
2 - تأخير إتامة الحد على المريض إلى أن يبرأ، غير حد الرجم.
(الزرقا ص 158) .
3 - عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء، سواء كان في الزوج أم في الزوجة.
(الزرقا ص 158) .
4 - جواز تأخير الصيام في شهر رمضان للمرض.
(الدعاس ص 31، اللحجي ص 38) .
5 - قلة عدالة الشهود، وقبول الأمثل فالأمثل بسبب المرض.
(الدعاس ص 31) .
6 - جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء.
(اللحجي ص 38) .
7 - عدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه.
(اللحجي ص 38) .
8 - جواز القعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة وفي النافلة مطلقاً.
(اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 447) .
9 - جواز الاضطجاع في الصلاة والإيماء فيها والجمع بين الصلاتين في وجه اختاره المحققون (اللحجي ص 38) .
10 - جواز التخلف عن الجمعة، والجماعة، مع حصول الفضيلة.
(اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 447) .
11 - جواز الخروج من المعتكف، وقطع التتابع المشروط في الاعتكاف.
(اللحجي ص 38) .
12 - جواز الاستنابة في الحج، وفي رمي الجمار، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
(اللحجي ص 38) .
13 - جواز التداوي بالنجاسات، وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوءتين.
(اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 444) .
ثالثاً: الإكراه، وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس أو قيد مَدِيدَين مطلقاً، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى إكراهاً ملجئاً، وبما يوجب غماً يعدم الرضا، وما كان بغير ذلك يسمى غير ملجئ.
وهو بقسميه إما أن يكون في العقود، أو في الإسقاطات، أو في المنهيات.
والعقود والإسقاطات إما أن يؤثر فيها الهزل أو لا، والمنهيات إما أن تكون مما يباح عند الضرورة أو لا، وما لا يباح عند الضرورة إما أن يكون جناية على الغير كقتل محقون الدم، أو قطع عضو محترم، أو لا يكون جناية على الغير كالردة، ويكون تأثير الإكراه كما فى: 1 - العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل، كالبيع والإجارة والرهن والهبة والإقرار والإبراء يؤثر فيها الإكراه، فإذا أكره عليها بملجئ أو بغير ملجئ ففعلها، ثم زال الإكراه، فله الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى.
(الزرقا ص 158) .
2 - العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل، كالنكاح والطلاق والعفو عن دم العمد، فلا تأثير للإكراه فيها، فلا خيار للمكرَه بعد زوال الإكراه، بل هي ماضية على الصحة، ولكن له أن يرجع على المكرِه له على الطلاق، فلو كانت الزوجة هي المكرِهة سقط المهر عن الزوج.
(الزرقا ص 158) .
3 - المنهيات التي تباح عند الضرورة، كإتلاف مال الغير، وشرب المسكر، فإنها تحلّ بل تجب بالملجئ، لا بغير الملجئ، وضمان المال المتلف على المكرِه.
(الزرقا ص 159، اللحجي ص 38) .
4 - المنهيات التي لا تباح عند الضرورة، وهي جناية على الغير كالزنى والقتل، فإنها لا تحل حتى بالإكراه الملجئ، ولو فعلها فموجبها القصاص على المكرِه بالكسر.
(الزرقا ص 159، اللحجي ص 38) .
5 - المنهيات التي ليست جناية على الغير، وليست في معنى الجناية، وهي الردة، فإنه يرخص له أن يجري كلمتها على لسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وُيوَرِّي وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يُورِّ يكفر وتبين زوجته.
(الزرقا ص 159، اللحجي ص 38) .
رابعاً: النسيان، وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، واتفق الفقهاء على أنه مسقط للعقاب والإثم، للحديث السابق، وهو مشقة تجلب التيسير، فمن ذلك: 1 - إذا وقع النسيان فيما يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها.
(الزرقا ص 159) .
2 - إذا نسي المدين الدَّين حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض، لم يؤاخذ به، بخلاف ما لو كان غصباً.
(الزرقا ص 159) .
3 - من جامع في نهار رمضان ناسياً للصوم فلا كفارة عليه، ولا يبطل صومه.
(اللحجي ص 38) .
4 - من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم عامداً لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته.
(اللحجي ص 38) .
خامساً: الجهل؛ وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير.
ويسقط الإثم، ومن تيسيراته: 1 - لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.
(الزرقا ص 160) .
2 - لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك.
(الزرقا ص 160) .
3 - لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش.
وقال: لم أعلم، تقبل دعواه.
(الزرقا ص 160) .
4 - لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح، فلا نضمن المهر.
(الزرقا ص 160) .
5 - إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون، جاهلاً بالهبة، لا يضمن.
(الزرقا ص 160) .
6 - لو أجاز الورثة الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به الميت، لا تصح إجازتهم.
(الزرقا ص 160) .
7 - لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيباً، واشتراه المشتري عالماً به، ولم يعلم أنه عيب، ثم علم أنه عيب، فإن له ردّه، ولا يُعَدُّ اطّلاعه عليه حين الشراء رضاً بالعيب.
(الزرقا ص 160) .
8 - العفو عن التناقض في الدعوى فيما كان سبجه خفياً، كالتناقض في النسب والطلاق، كما لو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه: إنه ليس ابني، ثم قال: هو ابني، يثبت النسب، لأن سبب البنوة العلوق منه، وهو خفي.
(الزرقا ص 160) .
9 - لو اختلعت المرأة من زوجها على بدل، ثم ادَّعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع، وبرهنت، فإنها تسترد البدل، ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الاختلاع، ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير، فإن الزوج يستبد به بدون علمها، فكانت معذورة.
(الزرقا ص 160) .
10 - من أسلم في دار الحرب، ولم تبلغه أحكام الشريعة، فتناول المحرمات جاهلاً حرمتها، فهو معذور.
(الزرقا ص 160) .
11 - من أتى بمفسد للعبادة جاهلاً كالأكل في الصلاة والصوم فلا تفسد العبادة.
(اللحجي ص 38) .
12 - إذا فعل ما ينافي الصلاة من كلام قليل وغيره جاهلاً بالحكم لم تفسد صلاته.
(اللحجي ص 38) .
13 - إذا فعل ما ينافي الصوم كالجماع جاهلاً بالحكم لم يفسد صومه.
(اللحجي ص 38) .
14 - من ابتدأ صيام شهرين يجب تتابعهما، ككفارة الظهار أو القتل، تتخللهما أيام الأضحى جاهلاً أن تخلل أيام الأضحى يفسد التتابع، فإنه يفطرها ويقضيها متصلة بصومه في الصحيح عند المالكية.
(الغرياني ص 138) .
سادساً: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (1) ، وله تيسيرات 1 - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.
(الزرقا ص 161) .
2 - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.
(الزرقا ص 161) .
3 - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.
(الزرقا ص 161) .
4 - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.
(اللحجي ص 38) .
5 - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.
(اللحجي ص 39) .
6 - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.
(اللحجي ص 39) .
7 - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.
(اللحجي ص 39) .
ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي: 1 - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.
(اللحجي ص 39) .
2 - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.
(اللحجي ص 39) .
3 - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.
(اللحجي ص 39) .
4 - مشروعية الطلاق، لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر.
(اللحجي ص 39) .
5 - مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيراً على المكلفين.
(اللحجي ص 39) .
6 - مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيراً على هذه الأمة.
(اللحجي ص 39) .
7 - مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من الرق.
(اللحجي ص 39) .
8 - مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حالة الحياة.
(اللحجي ص 39) .
9 - إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن.
(اللحجي ص 39) .
سابعاً: النقص؛ وهو ضد الكمال، فإنه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف، إذ النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود النقص كعدم تكليف الصبي، والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال، وفيه أمثلة: 1 - الصغر والجنون يجلبان التخفيف لعدم تكليفهما أصلاً فيما يرجع إلى خطاب التكليف في الوجوب والحرمة.
(الزرقا ص 161، اللحجي ص 39) .
2 - الأنوثة سبب للتخفيف، بعدم تكليف النساء بكثير مما كلف به الرجال، كالجهاد، والجزية، وتحمل الدية إذا كان القاتل غيرها، والجمعة، وإباحة لبس الحرير، وحلي الذهب.
(الزرقا ص 161، اللحجي ص 39) .
3 - عدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار، ككونه على النصف من الحر في الحدود والعدة.
(اللحجي ص 39) .
ثامناً: الاضطرار: كأكل الميتة عند من اضطره الجوع إليها، وشرب جرعة من الخمر عند الغصة، وسيرد المزيد من الأمثلة في قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".
المستثنى 1 - لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلو علق على فعل شيء، ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع، كما لو علق الطلاق على دخوله بيتاً، فدخله ناسياً فإنه يقع.
(الزرقا ص 159) .
2 - إن التخفيف بسبب النقص لا يؤثر في خطاب الوضع، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، ولذلك يجب العشر والخراج فيما خرج من أرض الصغير والمجنون، وتجب نفقة الزوجية والأقارب، وضمان المتلفات في مالهما، إلا ما قبضاه قرضاً أو وديعة أو عيناً اشترياها وتسلماها بدون إذن وليهما.
فإنهما لا تلزمهما في الجميع، لأنه مسلطان عليها بإذن المالك، وكذلك تجب عليهما الدية في القتل، وإقامة التعزير، وهذا في السبب، والقتل يمنع من الميراث، ولو كان من غير مكلف عند الشافعية.
وكذا في الشرط كما إذا عقد الصغير مع مثله عقداً فاقداً لشرط الصحة، فإنه يعتبر فاسداً، ويجب على الحاكم فسخه عليهما إن لم يفسخاه.
(الزرقا ص 161 - 162) .
3 - ويستثنى من كون العقود جائزة، لأن لزومها يشق، ما لو تقاسم الورثة التركة، ثم ادعى أحدهم أنها ملكه، وأراد نقض القسمة، لا تسمع دعواه.
(الدعاس ص 31) .
وكذاً لو باع شيئاً أو اشترى، ثم ادَّعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر، ولم يقبل بعقده، لا يسمع منه هذا الادعاء، لأن في ذلك نقضاً لما تمَّ.
(الدعاس ص 31) .
4 - ويستثنى من القاعدة ما له مساس بحق قاصر، أو وقف، أو بحقوق الجماعة، فالغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ، فلو باع الأب أو الوصي مال القاصر، أو أجر المتولي عقار الوقف، ثم ادّعوا وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم.
وكذا لو اشترى شخص أرضاً، ثم ادعى بأن بائعها كان وقفها مسجداً أو مقبرة، تسمع دعواه، صيانةً لحقوق القاصرين والجماعة، وإذا ثبت ذلك ينقض العقد.
وهذا استثناء من قاعدة أخرى "من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه ".
(م/99) .
فوائد مهمة الفائدة الأولى: في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف قال السيوطي: المشاق على قسمين: القسم الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً، كمشقة البرد في الوضوء.
والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل الجناة، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات والأحكام في كل الأوقات.
القسم الثاني: المشقة الي تنفك عنها العبادات غالباً، وهي على مراتب: الأولى: مشقة عظيمة فادحة (شديدة) كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف، ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعاً، لأن حفظ النفوس، والأطراف، لإقامة مصالح الدين، أولى من تعريضها للفوات في عبادة، أو عبادات يفوت بها أمثالها.
الثانية: مشقة خفيفة لا وقوع لها، كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في الرأس، أو سوء مزاج خفيف، فهذه لا أثر لها، ولا التفات إليها؛ لأن تحصيل مصالح العباد أولى من دفع هذه المفسدة التي لا أثر لها.
الثالثة: متوسطة بين هاتين المرتبتين، فمما دنا من المرتبة العليا، أوجب التخفيف، أو من الدنيا، لم يوجبه، كحمى خفيفة، ووجع الضرس اليسير، وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه، ولا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب.
وأشار الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى أن الأوْلى في ضبط مشاق العبادات: أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد، ثبتت الرخصة.
الفائدة الثانية: أنواع تخفيفات الشرع قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: تخفيفات الشرع ستة أنواع: الأول: تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار.
الثاني: تخفيف تنقيص، أي نقص من الواجب الأصلي، كالقصر في السفر، بناء على أن الفرض أربع ركعات.
الثالث: تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع والإيماء، وكإبدال الصيام بالإطعام.
الرابع: تخفيف تقديم، كجمع التقديم في السفر والمطر مطلقاً إذا لم يتخذ عادة عند جمع من المجتهدين وغيرهم، وكتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر في رمضان، والكفارة على الحنث.
الخامس: تخفيف تأخير، كجمع التأخير في السفر، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق، أو نحوه من أعذار الصلاة.
السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصة، وأكل النجاسة للتداوي، وإباحة اليتة للضرورة للترخيص في الأمور التي كانت صعبة ثم سهلها الشارع.
السابع: استدركه العلائي، وهو تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف.
وقد يقال: هو داخل في النقص، لأنه نقص عن نظمها الأصلي، أو داخل في الترخيص، وحينئذ فلا زيادة.
قال ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى: "ومن التخفيفات أيضاً أعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات، ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفاية، وسننها، والعمل بالظنون لمشقة الاطلاع على اليقين ".
الفائدة الثالثة، الرخص أقسام الأول: ما يجب فعلها، كأكل الميتة للمضطر الذي غلب على ظنه الهلاك.
وكالفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيماً صحيحاً، وكإساغة الغُضة بالخمر.
الثاني: ما يندب، كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث مراحل، وكالفطر لمن يشق عليه الصوم، في سفر أو مرض، وكالإبراد بالظهر، وكالنظر إلى الخطوبة.
الثالث: ما يباح، كالسَّلم، والصلح، والإجارة، باعتبار أصولها، لا باعتبار ما يطرأ عليها، فإنها قد تكون واجبة كإجارة القاضي أموال المفلس.
الرابع: ما الأولى تركها، كالمسح على الخف، والجمع، والفطر لمن لا يتضرر، وكالتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه.
الخامس: ما يكره فعلها، كالقصر في أقل من ثلاث مراحل خروجاً من خلاف أبي حنيفة.
قال المقري: "لا يُكره الأخذ بالرّخص الشرعية كالتعجيل في يومين، كما لا تكون أفضل من غيرها من حيث هي رخص، لكن يُكره تتبعها له، لئلا يؤدي إلى ترك العزائم، ويستحب تركها حيث قيل في محالِّها بالتحريم، خشية الرعي حول الحمى، ويجب فعلها، ويُندب إليه جث دلّ الدليل عليه ".
ويتفرع عن هذه القاعدة الأساسية الرابعة عدة قواعد فرعية، وهي القواعد الآتية.
What's Your Reaction?