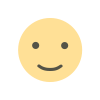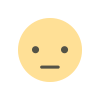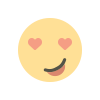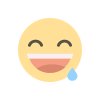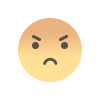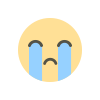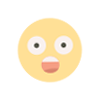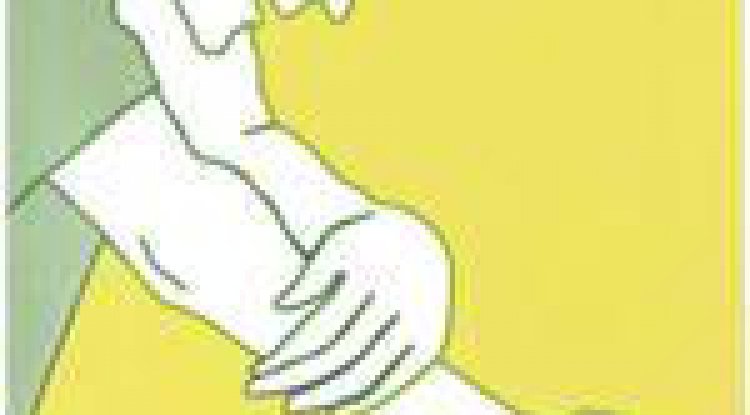القاعدة بمعنى الضابط في الأصل
تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها

أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه، مثل "لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن الزوج أو كان مسافراً " ومثل "أيما إهاب دُبغ فقد طَهُر" وهو نص حديث شريف، ومثل "كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور" ومثل "الكفار مخاطبون بفروع الشريعة" عند الشافعية.
ومثل "الإسلام يجبُّ ما قبله في حقوق الله.
دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال ".
يقول السيوطي: " لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعَ بابِ واحد".
ويقول أبو البقاء بعد تعريف القاعدة: "والضابط يجمع فروعاً من باب واحد".
وإن هذا التفريق بين القاعدة والضابط عند معظم العلماء فقط، كما أنه ليس تفريقاً حتماً جازماً، فقد يذكر كثير من العلماء قواعد فقهية، وهي في حقيقتها مجرد ضابط، كما سيمر معنا.
رابعاً: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية رأينا أن العلماء وضعوا قواعد أصولية للاستنباط والاجتهاد، وكان تدوينها مبكراً وسابقاً على القواعد الفقهية، وأول من دونها وجمعها في كتاب مستقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (ت 204 هـ) في كتا به (الرسالة) ثم تطورت وتوسعت وانتشرت وعمت المذاهب.
كما وضع الأئمة والعلماء قواعد فقهية لجمع الأحكام المتشابهة، والمسائل المتناظرة، وكانت مبعثرة في الكتب والأبواب الفقهية، وتأخر تدوينها وجمعها بشكل مستقل، كما سنرى.
وصرح القرافي بالنوعين السابقين، وميز بينهما، لكنه جمع في كتابه (الفروق) بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وكذلك فحل السيوطي الشافعي، وابن نجيم الحنفي، وابن اللحام الحنبلي، في كتابه (القواعد والفوائد الأصولية) وغيرهم.
ويمكن التمييز بين النوعين بما يلي: 1 - إن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية، والقواعد العربية، والنصوص العربية، كما صرح القرافي سابقاً، أما القواعد الفقهية فناشئة من الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية.
2 - إن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد، يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية، ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة في المصادر الشرعية، أما القواعد الفقهية فإنها خاصة بالفقيه، أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ويعتمد عليها بدلاً من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة.
3 - تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها، أما القواعد الفقهية فإنها، وإن كانت عامة وشاملة، تكثر فيها الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تشكل أحياناً قواعد مستقلة، أو قواعد فرعية، وهذا ما حدا بكثير من العلماء لاعتبار القواعد الفقهية قواعد أغلبية، وأنه لا يجوز الفتوى بمقتضاها.
4 - تتصف القواعد الأصولية بالثبات، فلا تتبدل ولا تتغير، أما القواعد الفقهية فليست ثابتة، وإنَّما تتغير - أحياناً - بتغير الأحكام المبنية على العرف، وسد الذرائع، والمصلحة وغيرها.
5 - إن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.
خامساً: الفرق بين القواعد والنطريات قلنا: إن الفقه الإسلامي بدأ بالفروع والجزئيات في التدوين، ثم انتقل إلى التقعيد بإقامة الضوابط الفقهية والقواعد الكلية.
وهذه الضوابط والقواعد مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة، والمبادئ العامة، لإقامة نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه، ولكن الظروف التي مرت بالأمة الإسلامية، وأحاطت بالاجتهاد والمجتهدين والعلماء، أوقفت العمل عند مرحلة القواعد، إلى أن ظهرت في هذا القرن النهضة الفقهية والدراسات المقارنة، وشرع العلماء في صياغة النظريات الأساسية في الفقه الإسلامي، مثل: نظرية العقد، ونظرية الملكية، ونظرية الأهلية، ونظرية الفساد، ونظرية البطلان، ونظرية الشروط المقترنة بالعقد، ونظرية العقد الموقوف، ونظرية الضرورة، ونظرية الضمان، ونظرية الإثبات، ونظام الحكم في الإسلام، ونظام المال في الإسلام، ونظرية التكافل الاجتماعي، ونظام الجهاد، وغيرهما، مما يتيح للباحث أو الدارس أن يحصل على منهج الإسلام العام، وآراء الفقهاء في كل جانب من جوانب التشريع الأساسي في الإسلام.
والفرق بين القواعد الفقهية وبين النظريات أن القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تجمع الفروع والجزئيات، ويعتمد عليها الفقيه والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية.
أما النظريات الفقهية فهي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظاماً متكاملاً في جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع، وأن كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية.
كما تقوم النظرية على أركان وشروط ومقومات أساسية، وكثيراً ما تخلو من بيان الأحكام الفقهية، أما القواعد فلا يوجد لها أركان وشروط، وتنطوي على عدد كبير من الأحكام الفقهية والفروع والمسائل.
مثال القواعد " الفقهية " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني " التي تفسر صيغة العقد، وموضوعه، لتحديد الآثار المترتبة عليه.
ومثال النظريات الفقهية (نظرية العقد) التي تتناول جميع العقود الشرعية في مختلف أحكامها وأطرافها من التعريف والأركان والشروط والآثار، وموقع العقد بين مصادر الالتزام الأخرى.
والخلاصة: أن القواعد واسطة بين الفروع والأصول، أو هي واسطة بين الأحكام والنظريات.
ونشير هنا إلى أهم تطور للفقه الإسلامي في العصر الحاضر، وذلك بتقنين أحكامه في قانون أو نظام في مجال معين، واختيار الآراء فيه من مختلف المذاهب الفقهية.
والتزام القضاة العمل بموجبه، ويختلف ذلك سعة وضيقاً، وشمولاً وحصراً من بلد إلى آخر، وكان أقدم قانون (مجلة الأحكام العدلية) في الدولة العثمانية التي سنشير إليها، وآخرها قانون العقوبات في الفقه الإسلامي الذي صدر بالسودان، والتقنين مستمر.
سادساً: فوائد القواعد الفقهية وأهميتها بيَّن لنا العلامة القرافي أهمية القواعد وفوائدها فقال: "وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، ومن جعل يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد - عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب ".
وقال العلامة ابن نجيم مبيناً فوائد القواعد: "الأول: في معرفة القواعد التي تُردُّ إليها، وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصل الفقه، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، ولو بالفتوى".
وممكننا أن نلخص فوائد القواعد وأهميتها بما يلي: 1 - إن دراسة الفروع والجزئيات الفقهية يكاد يكون مستحيلاً، بينما يدرس الطالب والعالم قاعدة كلية تنطبق على فروع كثيرة لا حصر لها، ويتذكر القاعدة ليفرع عليها المسائل والفروع المتشابهة والمتناظرة، ولذلك سمي هذا العلم أيضاً: علم الأشباه والنظائر.
يقول العلامة السيوطي: "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مرِّ الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر".
فهي تسهل ضبط الأحكام الفقهية، وحصرها، وحفظ المسائل الفرعية وجمعها.
2 - إن دراسة الفروع والجزئيات، إن حفظت كلها أو أغلبها، فإنها سريعة النسيان، ويحتاج الرجوع إليها في كل مرة إلى جهد ومشقة وحرج.
أما القاعدة الفقهية فهي سهلة الحفظ، بعيدة النسيان، لأنها صيغت بعبارة جامعة سهلة تبين محتواها، ومتى ذكر أمام الفقيه فرع أو مسألة فإنه يتذكر القاعدة، مثل قاعدة " لا ضرر ولا ضرار"، أو "الضرر يزال "، أو " يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام "، أو "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة".
3 - إن الأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بين عللها، فيقع الطالب والباحث في الارتباك والخلط، وتشتبه عليه الأمور حتى يبذل الجهد والتتبع لمعرفة الحقيقة.
أما القاعدة الفقهية فإنها تضبط المسائل الفقهية، وتنسق بين الأحكام المتشابهة، وترد الفروع إلى أصولها، وتسهل على الطالب إدراكها وأخذها وفهمها.
4 - إن القواعد الكلية تسهل على رجال التشريع غير المختصين بالشريعة فرصة الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه وأسسه وأهدافه، وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه، ومراعاة الحقوق والواجبات فيه، وهذا ما حققته القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية، والتي انتقلت إلى العديد من القوانين المعاصرة.
5 - تكوِّن القواعد الكلية عند الطالب ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسع، ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، والمشأكل المتكررة، والحوادث الجديدة.
6 - تساعد القواعد الكلية في إدراك مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة؛ لأن مضمون القواعد الفقهية يعطي تصوراً واضحاً عن المقاصد والغايات، مثل "المشقة تجلب التيْسير"، أو "الرخص لا تناط بالمعاصي "، أو "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، وغير ذلك من الفوائد والمنافع الي تحصل من دراسة القواعد الفقهية.
سابعاً: مصادر القواعد الفقهية إن القواعد الكلية في الفقه الإسلامي - بصيغتها الأخيرة - هي من وضع الفقهاء وصياغتهم وترتيبهم، وقد فعلوا ذلك على مر العصور، وحتى العصر الحاضر.
أما أصلها ونشأتها فمستقاة من ثلاثة مصادر، هي: 1 - القرآن الكريم لقد جاء القرآن الكريم بمبادئ عامة، وقواعد كلية، وضوابط شرعية، في آياته ونصوصه، لتكون مناراً وهداية للعلماء في وضع التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة، وأغراضها العامة، وتتفق مع مصالح الناس، وتطور الأزمان، واختلاف الببئات.
وقد حققت هذه المبادئ العامة في القرآن الكريم هدفين أساسيين.
الأول: تأكيد الكمال في دين الله تعالى الذي ورد في قوله تعالى:.
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) .
والثاني: بيان ميزة المرونة في التشريع الإسلامي لمسايرة جميع العصور والبيئات، ليبقى صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان.
وهذه المبادئ العامة في القرآن الكريم كانت مصدراً مباشراً للأئمة والفقهاء في صياغة القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، وإرشادهم إلى المقاصد والغايات من الأحكام، والاستعانة بها لتشمل جميع الفروع التي تدخل تحتها، مثل قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) .
فالآية تصف المؤمنين بالتشاور في جميع الأمور، سواء كانت عائلية أو اجتماعية أو إدارية أو سياسية، وتركت كيفية التنفيذ ووسائله بحسب الأحوال والأزمان، ومثل قوله تعالى:.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .
التي تحتبر قاعدة عامة لتحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين.
ومثل قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ، التي تقرر مبدأ التراضي في العقود والتصرفات، واحترام سلطان الإرادة.
وسترد أمثلة أخرى، كما سترى أن كثيراً من القواعد الفقهية ترجع في أصلها إلى آيات الذكر الحكيم.
2 - السنة النبوية لقد أعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً، وكان عليه الصلاة والسلام ينطق بالحكمة القصيرة التي تخرج مخرج المثل، وتكون قاعدة كلية.
ومبدأ عاماً، ينطوي على الأحكام الكثيرة، والمسائل المتعددة، والفروع المتكررة.
مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " المسلمون على شروطهم ".
وقوله: "إنما الأعمال بالنيات ".
وقوله: (الدين النصيحة "، وقوله: " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رَدّ "، وقوله: " الخَرَاج بالضَّمَان، وقوله عليه الصلاة والسلام: " الحلال بَيِّن والحرام بَيِّن ".
وسترد أمثلة أخرى كثيرة، وسترى أن بعض القواعد الفقهية هي نص حديث نبوي شريف، وأن كثيراً من القواعد الفقهية ترجع في أصلها واستنباطها إلى الأحاديث الشريفة.
3 - الاجتهاد وذلك باستنباط القواعد الكلية من الأصول الشرعية السابقة، ومن مبادئ اللغة العربية، ومسلمات المنطق، ومقتضيات العقول، وتجميع الفروع الفقهية المتشابهة في علة الاستنباط، فالعالم الفقيه يرجع إلى هذه المصادر، ويبذل جهده فيها، ويجمع بين الأحكام المتماثلة، والمسائل المتناظرة، ويستخرج قاعدة كلية منها، تشمل كل ما يدخل تحتها أو أغلبه، وكما فعل علماء الأصول في وضع القواعد الأصولية، سار الفقهاء في القواعد الفقهية.
مثل قاعدة "الأمور بمقاصدها" المأخوذة من مجموعة أحاديث في النية، أهمها حديث "إنما الأعمال بالنيات "، ومثل قاعدة "الضرر يزال " المأخوذة من حديث " لا ضرر ولا ضرار"، ومثل قاعدة "المرء مؤاخذ بإقراره " المأخوذة من قوله تعالى: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) .
ومثل قاعدة "السؤال معاد في الجواب " المأخوذة من مبادئ اللغة العربية، ومثل قاعدة "الأصل في الكلام الحقيقة " المأخوذة من اللغة العربية، وقاعدة "التابع تابع " المأخوذة من مسلمات المنطق، ومثل قاعدة "إذا تعذر إعمال الكلام جهمل ".
وقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع " المأخوذة من لوازم التفكير ومبادئ العقل.
ثامناً: أنواع القواعد الفقهية إن تعريف القاعدة السابقة يشمل جميع القواعد، ولكن القواعد الفقهية على درجات في العموم والشمول، والاتفاق عليها بين المذاهب الفقهية عامة، أو الاختلاف فيها بين المذاهب، ولكنها شاملة في المذهب الواحد، وبعضها قواعد مختلف فيها في المذهب الواحد، لذلك كانت القواعد الفقهية على أنواع هي: 1 - القواعد الفقهية الأساسية الكبرى، التي تدور معظم مسائل الفقه حولها، حتى رد بعض العلماء الفقه كله إليها، وهي متفق عليها بين جميع المذاهب، وهي: أ - الأمور بمقاصدها.
ب - اليقين لا يزول بالشَّك.
جـ - المشقة تجلب التيسير.
د - الضرر يزال.
هـ - العادة مُحكمة (1) .
2 - القواعد الكلية: وهي قواعد كلية مُسَلَّم بها في المذاهب، ولكنها أقل فروعاً من القواعد الأساسية، وأقل شمولاً من القواعد السابقة، مثل قاعدة: "الخراج بالضمان "، وقاعدة "الضرر الأشد يُدفَعُ بالضرر الأخف ".
وكثير من هذه القواعد تدخل تحت القواعد الأساسية الخمس، أو تدخل تحت قاعدة أعم منها، ومعظمها نصت عليها مجلة الأحكام العدلية، وقد يدخل تحتها قواعد فرعية أيضاً، وأكثرها متفق عليها بين المذاهب.
3 - القواعد المذهبية: وهي قواعد كلية في بعض المذاهب دون بعض، وهي قسمان، الأول: قواعد مقررة ومتفق عليها في المذهب، والثاني: قواعد مختلف فيها في المذهب الواحد، مثل قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني " فإنها أغلبية في المذهب الحنفي والمالكي، ولكنها قليلة التطبيق في المذهب الشافعي، وقاعدة " من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه " فهي كثيرة التطبيق في المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي، نادرة التطبيق عند الشافعية.
ومثل قاعدة " الزُخص لا تُنَاط بالمعاصي " فإنها شائعة عند الشافعية والحنابلة، دون الحنفية، وفيها تفصيل عند المالكية.
4 - القواعد المختلف فيها في المذهب الواحد، فتطبق في بعض الفروع دون بعض، وهي مختلف فيها في فروع المذهب الواحد.
مثل: قاعدة "هل العبرة بالحال أو بالمآل "؟! فهي قاعدة مختلف فيها في المذهب الشافعي، ولها أمثلة كثيرة، ولذلك تبدأ غالباً بكلمة " هل؛ "، وقاعدة "هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود "؟! عند المالكية، وقاعدة "القسمة، هل هي إفراز، أم بيع؛ " عند الشافعية والحنابلة.
وقد راعى العلماء هذا التنويع للقواعد في تقسيم الدراسة.
وتصنيف القواعد.
وسوف يكون هو المعيار الأساسي في تقسيم القواعد التي سندرسها إن شاء الله تعالى.
تاسعاً: مؤلفات القواعد الفقهية بدأت صياغة القواعد الفقهية في عصر متقدم، وذلك منذ القرن الثاني الهجري، ولكنها لم تُفرد في التأليف والتصنيف والتدوين بشكل مستقل إلا بعد قرنين تقريباً.
وكانت المذاهب الفقهية قد نضجت وتبلورت، فأخذ تأليف القواعد طابع المذاهب الفقهية، واتجه علماء كل مذهب لكتابة القواعد في مذهبه، ولكن جاءت صياغة القواعد غالباً عامة وواحدة ومشتركة بين المذاهب، وتختلف الفروع التي تدخل تحتها.
وأول من بدأ في تدوين القواعد - فيما وصلنا - أبو طاهر الدَّباس إمام الحنفية فيما وراء النهر، وردَّ قواعد مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، وسافر إليه العلماء لأخذها عنه.
ولما بلغ ذلك القاضي حسين إمام الشافعية في زمانه ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد؛ ثم استمر التصنيف والإضافة والزيادة على هذه القواعد، وانتقل العمل إلى بقية المذاهب، وظهرت القواعد بعدة أسماء، مثل: كتب الأشباه والنظائر، وكتب الفروق، وكتب القواعد، وهذه إشارة لبعضها في كل مذهب.
أ - كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي 1 - أول من بدأ التصنيف في القواعد - فيما نعلم - أبو طاهر الدَّباس الذي جمع سبع عشرة قاعدة في الفقه الحنفي، وصار يكررها كل ليلة في مسجده، ويعيدها ويصقلها، ولم تذكر كتب التراجم تاريخ وفاته، ولكن كان ذلك في القرن الرابع الهجري.
2 - أخذ أبو الحسن الكرخي (المتوفى سنة 340 هـ) عن أبي طاهر الدباس، وكان معاصراً له، وزاد على قواعده، ودونها في رسالة (الأصول) التي جمع فيها فروع المذهب الحنفي.
3 - ثم جاء أبو زيد الدَّبُوسىِ (وهو عبيد الله بن عمر بن عسيى 430 هـ) وألف كتاب (تأسيس النظر في الأصول) وضمنه القواعد الكلية للفقه، مع الضوابط الفقهية، وبين أساس الاختلاف بين الأئمة.
4 - ثم جاء بعد ذلك نجم الدين عمر النسفي (المتوفى سنة 537 هـ) وتناول قواعد الكرخي، وذكر الأمثلة والشواهد لكل قاعدة من القواعد، وما تشتمل من الفروع الفقهية، والأحكام المستنبطة على المذهب الحنفي.
5 - وصنف الإمام أبو المظفر أسعد بن محمد الكرابيسي (570 هـ) كتاب (الفروق) بحسب الأبواب الفقهية، ورتبه على بحوث، واشتمل كل بحث على مسألتين في الغالب، أو أكثر، وبين الفرق بين المسألتين أو المسائل المذكورة، ورد الخلاف في بعضها إلى الخلاف في القواعد الفقهية التي تندرج تحتها، فذكر القواعد الكلية عرضاً.
6 - وانتقلت هذه القواعد مع شواهدها وأمثلتها من كتاب إلى آخر، حتى جاء العلامة إبراهيم بن نجيم المصري (975 هـ) وألف كتابه (الأشباه والنظائر) الذي جمع فيه القواعد الكلية، ورتبها، وصنفها، وقسمها، وبين الفروع التي تشتمل عليها، ثم ذكر أصل القاعدة، والمسائل التي تستثنى منها، ورتب كتابه على سبعة فنون، الأول: في معرفة القواعد، وأنها أصل الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، ولو في الفتوى، والثاني: فن الضوابط، وهو أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي.
إلخ.
وصرح في مقدمة الكتاب أنه يريد أن يحاكي كتب الشافعية في القواعد، فقال "وإن المشايخ الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطَوَّل من متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى، إلا أني لم أر لهم كتاباً يحاكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي، مشتملاً على فنون في الفقه.
فألهمت أن أصنع كتاباً على النمط السابق ".
7 - مجامع الحقائق، للفقيه الحنفي أبي سعيد محمد الخادمي (1155 هـ) وهو في أصول الفقه؛ ولكن المؤلف ضمنه القواعد الفقهية في أربع وخمسين قاعدة في نهاية الكتاب، ثم جاء مصطفى محمد الكوز الحصاري، وشرح هذه القواعد في كتابه (منافع الدقائق) وسار الخادمي في كتابه على طريقة الزركشي الشافعي (794 هـ) في كتابه.
8 - ثم جاء مفى دمشق، في عهد السلطان عبد الحميد، الشيخ محمود حمزة الدمشقي الحنفي (1305 هـ) وألف كتاباً في القواعد باسم (الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) وصنف القواعد بحسب أبواب الفقه، وذكر لكل قاعدة مصدرها الفقهي، وفروعها التي تدخل تحتها.
أما القواعد الفقهية في (جملة الأحكام العدلية) فسوف نفصل الكلام عنها في فقرة مستقلة، مع بيان شروحها.
9 - وفي العصر الحاضر قام أستاذنا الجليل، العلامة المحقق المدقق، الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، بدراسة معمقة عن القواعد الفقهية في المذهب الحنفي في الباب السادس من كتابه القيم النافع الفريد (المدخل الفقهي العام) فعرض القواعد الفقهية الواردة في مجلة الأحكام العدلية، وصنفها تصنيفاً علمياً مفيداً، ورتبها ترتيباً مميزاً، وقسمها إلى أساسية وفرعية، فبلغت الأساسية أربعين قاعدة، واندرجت سائر القواعد التسع والتسعين تحت الأربعين، وقدم دراسة، لم يسبق إليها، عن تاريخ نشأة القواعد، وأطوار صياغتها، وقدم شرحاً موجزاً ومختصراً ومركزاً لمفاهيمها.
وذكر أدلتها، وبعض الأمثلة الفقهية لكل قاعدة، ثم وضع فهرسة خاصة لقواعد المجلة مرتبة ترتيباً أبجدياً، وفهرسة خاصة للمصطلحات الفقهية الواردة في قواعد المجلة.
ثم أردف ذلك بقواعد يحسن إلحاقها بالقواعد السابقة، جمعها من مناسباتها المختلفة في الكتب الفقهية، وبعضها عبارات مأثورة عن بعض الأئمة الفقهاء، وبلغت 31 قاعدة، ورتبها على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها.
ب - كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي 1 - أصول الفتيا، لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني القيروافي (361هـ) ، وهو يتضمن أصولاً مالكية، ونظائر في الفروع، وبعض الكليات، ورتبه المؤلف على أبواب الفقه، ثم أضاف إليه أبواباً أخرى، وكان يفتتح غالب أبوابه بأصل فقهي من أصول المالكية، وهو كقاعدة فقهية، كقوله في باب حد الزنى: "من أصول هذا الباب قوله: "الحدود تُدْرَأ بالشبهات، ولا يقام مع الرجم شيء من الحدود ولا من القصاص ".
2 - الفروق، للقرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المالكي المتوفى سنة 684 هـ جمع فيه المؤلف القواعد الكلية والضوابط الفقهية، وقارن بينها، وذكر أوجه الشبه بين كل قاعدتين، أو ضابطين، أو أصلين، أو مصطلحين، وذكر أوجه الافتراق بين كل ذلك، وعليه (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية) للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين، مفتي المالكية بمكة المكرمة.
3 - ادرار الشروق على أنواء الفروق، لأبي القاسم، قاسم بن عبد الله الأنصاري، المعروف بابن الشاط، المتوفى سنة 723 هـ، تعقب فيه القرافي في قواعده، ورجح بعض الأقوال، وصحح بعض الحالات، لكن الحق مع القرافي في كثير من المسائل.
4 - القواعد، للمَقَّري، أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني، قاضي الجماعة بفاس، المتوفى سنة 758 هـ.
واشتمل الكتاب على ألف ومئتي قاعدة.
قال العلامة الشيخ محمد بن محمد مخلوف عنه: " وهو كتاب غزير مفيد، لم يسبق إليه أحد ".
5 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي، أبي العباس أحمد بن يحيى، المتوفى سنة 914 هـ، وهو كتاب قيم ومفيد، اشتمل على 118 قاعدة، وهي غير مرتبة، بدأها بقاعدة مختلف فيها وهي " الغالب هل هو كالمحقق "، وختمها بقاعدة " كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى ".
وهو أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي.
6 - شرح المنهج المنتخب، لأحمد بن علي المنجور المالكي (995 هـ) ، حققه الشيخ محمد بن الشيخ محمد الأمين، ونشرته دار عبد الله الشنقيطي، وهو شرح لمنظومة (المنهج المنتخب) لأبي الحسن علي بن قاسم الزفاق المالكي (912 هـ) وبلغ عدد أبياتها.
(443) بيتاً، مرتبة على الأبواب الفقهية، واستخلص القواعد من كتب السابقين من علماء المالكية، وخاصة من قواعد المقري (758 هـ) ، وجاء شرح المنهج المنتخب للمنجور مطولاً، ونال شهرة عند المالكية، وصنفت كتب كثيرة حول المنظومة والشرح، منها (الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج على قواعد المذهب) ، لأبي القاسم بن محمد بن أحمد التواني من علماء المالكية المعاصرين، وطبع للمرة الأولى في المطبعة الأهلية في بنغازي سنة 1395 ص/1975 م.
جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي) قلنا: إن القواعد بدأت بالظهور في القرن الثاني الهجري، وكانت على قسمين " أصولية، وقواعد فقهية، وكان الإمام الشافعي أول من وضع القواعد الأصولية ودونها، أما القواعد الفقهية فسبق فيها علماء الحنفية، وإن أقدم من وضع القواعد الفقهية وصاغها ودونها في الفقه الشافعي - فيما نعلم - القاضي حسين (المتوفى سنة 462 هـ) وكان إماماً كبيراً، وصاحب وجه في المذهب، وصنف في الأصول والفروع والخلاف، وإذا أطلق لفظإ القاضي " في الفقه الشافعي فهو المراد.
ثم صار مذهب الشافعية أكثر المذاهب اهتماماً وتأليفاً في القواعد الفقهية.
وصنفت كتب مستقلة بذلك على المذهب الشافعي، منها: 1 - الفروق، لوالد إمام الحرمين، أبي محمد الجويني، عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيوية (438 هـ) ، أظهر الفرق بين المسائل بتعمق، ورتبه على أبواب الفقه، ووضع كل مجموعة من المسائل بعنوان تندرج تحته.
2 - قواعد في فروع الشافعية، للجاجرمي، معين الدين، أبي حامد محمد بن إبراهيم الشافعي المتوفى سنة 613 هـ، وقد أكثر الناس من الاشتغال بها في عصره، كما يقول العلامة ملاجلبي.
3 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (660 هـ) .
وتسمى القواعد الكبرى في فروع الشافعية، وله القواعد الصغرى، وكان من تلامذته القرافي المالكي صاحب (الفروق) ، واعتبر العز أن الأحكام كلها ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي "جلب المصالح ودرء المفاسد" أو إلى "درء المفاسد" فقط.
4 - الأشباه والنظائر، لابن الوكيل، صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل الشافعي المتوفى سنة 716 هـ، جمع فيه قواعد المذاهب الشافعي، وذكر معظم مسائله من كتاب (فتح العزيز) للرافعي (ت 623 هـ) شيخ الشافعية، ومحقق المذهب مع النَّووي، لكن الكتاب غير مرتب، لأن مؤلفه مات قبل أن ينقحه، ويحتوي على قواعد فقهية وأصولية وضوابط فقهية، ثم جاء ابن أخيه زين الدين بن المُرَحِّل (738 هـ) فنقحه، وتبعه العلماء في تنقيحه.
5 - المجموع المُذْهَبُ في قواعد المذهب الشافعي، للعلائي، صلاح الدين بن خليل كَيْكَلدي العلائي الشافعي الحافظ الدمشقي المتوفى سنة 761 هـ) وقال عنه ملاجلبي: "وهي أجود القواعد، اختصرها الشيخ محمد بن عبد الله الصرخدي المتوفى سنة 792 هـ) ، وفيه أحاديث كثيرة وقواعد أصولية عديدة أيضاً.
6 - الأشباه والنظائر، لابن السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 771 هـ) وهو الكتاب المشهور الذي اعتمد عليه السيوطي في (الأشباه والنظائر) ، وأراد ابن نجيم أن يحاكيه بوضع كتاب مثله في المذهب الحنفي، وهو من أحسن الكتب لما يمتاز به مؤلفه من دقة واحاطة بالفقه والأصول وغيرهما، مع حسن الترتيب.
7 - الأشباه والنظائر، للأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772 هـ) ولكن ابن السبكي يقول عنه: " فيه أوهام كثيرة، لأنه مات عن مسودة ".
8 - القواعد في الفقه، أو المنثور في القواعد، للزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، المتوفى سنة 794 هـ) وهو كتاب فريد في منهجه، عميق في أسلوبه، رتبه على حروف المعجم، وشرحه سراج الدين العبادي في مجلدين، واختصر الأصل الشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 973 هـ في مجلد.
9 - القواعد، للغزي، شرف الدين علي بن عثمان الغزي المتوفى سنة 799 هـ) وصنفه على طريقة ذكر القاعدة، وما يستثنى منها، ثم أدخل الألغاز فيها.
10 - نواظر النظائر، لابن المُلَقن، سراج الدين عمر بن علي، المعروف بابن الملقن الشافعي المتوفى سنة 804 هـ) وهو مختصر الأشباه والنظائر لابن السبكي.
11 - الأشباه والنظائر، للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، المتوفى سنة 911 هـ) وهو من أحسن كتب القواعد، وأجمعها، وأشلها، استفاد السيوطي ممن قبله، وبخاصة التاج السبكي والحافظ العلائي والزركشي، وأحال على السبكي والزركشي دون العلائي، وأضاف إلى ذلك خلاصة علمه ودرايته في الفقه والأصول والعربية، ورتبه على سبعة كتب، أهمها الأول في شرح القواعد الخمس، والثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، والثالث في القواعد المختلف فيها.
وقال السيوطي: " أول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام ابن عبد السلام في.
(قواعده الكبرى) ، فتبعه الزركشي في (القواعد) وابن الوكيل في (أشباهه) وقد قصد ابن السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل، وذلك بإشارة والده ".
12 - الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية والضوابط والقواعد الكلية.
للسقاف، السيد علوي بن أحمد السقاف، ثم اختصره المؤلف في كتابه (مختصر الفوائد المكية) .
د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي) يقول الشيخ محمد حسن الشطي الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 1307 هـ في مقدمة (توفيق المواد النظامية لأحكام الشريعة المحمدية) : "إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وقد أوصلها فقهاء الحنابلة إلى نحو ثمان مئة قاعدة ".
وإن أهم كتب القواعد على المذهب الحنبلي - التي وصلت إلى علمنا - هي 1 - الفروق، للسامري، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي، المعروف بابن سُنَيْنة، مجتهد المذهب (616 هـ) ، ذكر فيه المسائل المشتبهة صورة، المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها، وسبب الفرق من حديث أو من القواعد الأصولية ".
2 - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر، للصرصري، سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي (المتوفى سنة 710 هـ وقيل 716 هـ) ، ويسمى كتابه (القواعد الكبرى في فروع الحنابلة) .
وللمؤلف (القواعد الصغرى) أيضاً.
3 - القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، المتوفى سنة 728 هـ، وهي قواعد موزعة على أبواب العبادات ثم المعاملات، ويورد في أثناء البحث بعض القواعد الفقهية، ويمتاز بالمقارنة مع بقية المذاهب، مثل القاعدة الثالثة في العقود، والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما صح منها ويفسد، ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً، والذي يمكن ضبطه فيها قولان: أحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك: " الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته"، ويطنب ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك كعادته، ويبحث الموضوع من مختلف جوانبه، والواقع أن هذه القاعدة أقرب إلى النظرية العامة في الشروط أكثر من القواعد الكلية.
4 - القواعد، لابن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عمر المقدسي، المتوفى سنة 771 هـ، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية.
5 - القواعد، ل (ابن رجب، الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ، وسماها المؤلف (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لكنه مشهور باسم (القواعد) في الفقه الإسلامي، قال ملاجلبي عنه: "وهو كتاب نافع من عجائب الدهر ".
ويتألف الكتاب من مئة وستين قاعدة، وإحدى وعشرين مسألة، تتضمن فوائد فقهية جمة، وأحكاماً شرعية كثيرة، وفيها القواعد الفقهية والضوابط، والقواعد الأصولية، وفروع فقهية، ولكن بأسلوب خاص، ومنهج يقرب من الفقه أكثر من القواعد.
6 - القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لابن اللحام علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى سنة 803 هـ) وهذا الكتاب يحتوي على القواعد الأصولية، وما يتفرع عنها من فروع فقهية، مع المقارنة بين المذاهب، ويضم بين دفتيه بعض القواعد الفقهية مع ذكر الضوابط والمسائل والأحكام الشرعية التي تدخل تحتها.
7 - كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية، تصنيف الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي (909 هـ) حققه وعلق عليه جاسم ابن سليمان الفُهيد الذوسري، وطبعته دار البشائر الإسلامية، بيروت - ط 1، 1415 هـ / 1994 م) وهذا الكتاب لا يتضمن القواعد الفقهية الكلية إلا نادراً.
وأغلبه ضوابط مختصة بابواب محدّدة، وأحكام فرعية جزئية على صيغة حكم عام.
8 - رسالة في القواعد الفقهية، تأليف عبد الرحمن السعدي، أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر عبد الله السعدي الحنبلي، ولد بعنيزة سنة 1357) وصار عالم القصيم، وتوفى سنة 1376 هـ) ، وهي منظومة من 47 بيتاً، ثم شرحها المؤلف شرحاً وجيزاً، دون أن يذكر لذلك الفروع الفقهية الي تندرج تحتها إلا في بعض الأمثلة الإجمالية.
وللمؤلف كتاب بعنوان (الرياض الناضرة) ذكر فيه فصلاً عن "التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة" ذكر تحته 74 قاعدة وضابطاً.
هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية) سارت القواعد الفقهية شوطاً ممتازاً، وتقدمت خطوة جيدة في العصر الحديث، وذلك من حيث الصياغة والتطبيق والشهرة، والاعتماد عليها في الإطار التشريعي والقضائي، فقد رأت اللجنة المكلفة بوضع مجلة الأحكام العدلية في المعاملات المالية من الأحكام الشرعية في الخلافة العثمانية، رأت اللجنة أن تتوج عملها بوضع مقدمة لمواد المجلة بذكر القواعد الكلية، في أولها، للرجوع إليها، والاعتماد عليها، فأخذت القواعد التي جمعها ابن نجيم، وأضافت إليها بعض القواعد الأخرى، وعدلت في الصياغة والأسلوب.
وصدرت المجلة عام 1286 هـ، وبدأ العمل بها عام 1293 هـ / 1876 م، وفي أولها تسع وتسعون قاعدة، كل قاعدة في مادة مستقلة، من المادة الثانية إلى المادة المئة، ولكنها جاءت غير مرتبة، بحسب الحروف أو الأبواب الفقهية، وإنما ذكرت بشكل عشوائي.
ونصت على الهدف والغرض من القواعد الكلية في نهاية المادة الأولى، فقالت: "إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة، معتبرة في الكتب الفقهية، تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان، فلذا جُمعَ تسعٌ وتسعون قاعدةً فقهية".
ثم قالت: "ثم إن بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات، لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، كما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً".
وتولى شراح المجلة البدء بشرح هذه القواعد، وبيان أهميتها، ودلالاتها، والفروع الفقهية التي تدخل تحتها، والمسائل الجزئية التي تتناولها، والمستثنيات التي تخرج منها، وكثير من هذه الشروح باللغة التركية، وترجم بعضها أحياناً، ووضعت شروح مستقلة باللغة العربية، منها: 1 - شرح المجلة، للشيخ محمد خالد الأتاسي، والشيخ محمد طاهر الأتاسي، والشرح مكون من ستة أجزاء، وخصص الجزء الأول منها للقواعد الكلية.
2 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف علي حيدر، وتعريب فهمي الحسيني، جزءان.
3 - شرح المجلة، سليم رستم باز اللبناني، وهو مجلد ضخم يقع في 1288 صفحة، ومطبوع في جزأين أيضاً، وفي أوله شرح القواعد الفقهية.
4 - مرآة المجلة، يوسف آصاف، جزءان.
5 - شرح مجلة الأحكام العدلية، للأستاذ محمد سعيد المحاسني، ثلاثة أجزاء.
6 - شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن محمد الزرقا الحلبي (ت 1357 هـ) .
وهو شرح خاص بالقواعد الفقهية الواردة في مجلة الأحكام العدلية، بمنهج سديد، وذلك بتوضيح معنى القاعدة لغة، مع شرح مصطلحاتها، وبيان معناها والمراد منها.
ثم ذكر المسائل التطبيقية لها من فروع الحنفية حصراً، ثم بيان المستثنيات من القاعدة، وإضافة الفوائد الفقهية، والتنبيهات الضرورية التي لها صلة بالقاعدة، مع نسبة الآراء والأقوال والنصوص إلى الكتب المقتبسة منها، لكن المؤلف لم يرتب هذه القواعد، بل عرضها كما جاءت في المجلة بدون ترتيب.
7 - القواعد الفقهية، مع الشرح الموجز، للأستاذ الشيخ عزت عبيد الدعاس، وهو كتاب صغير في 90 صفحة، فيه مقدمة عن القواعد الفقهية، ثم عرض لقواعد المجلة، مع ترتيبها وتقسيمها إلى قواعد أساسية، وقواعد متفرعة عنها، وهو شرح موجز كما رحمه المؤلف لتوضيح معنى القاعدة باختصار، وبيان أصلها أحياناً.
وذكر بعض الفروع التطبيقية، وإيراد بعض المستثنيات.
ويحسن الإشارة هنا إلى أن مجلة الأحكام العدلية كانت تمثل القانون المدني للمعاملات في ظل الدولة العثمانية، وكانت تطبق عل جميع الأقطار التي كانت تظلها الدولة العثمانية، ثم ألغيت المجلة بالتدريج في تركية وسورية والعراق والكويت، ولم تطبق أصلاً في مصر، ووضع مكانها القوانين المدنية الأجنبية المستمدة من القانون المدني الفرنسي (قانون نابليون) وغيره، مع تطعيمها بالفقه الإسلامي أحياناً، وظلت المجلة مطبقة إلى عهد قريب في الأردن وفلسطين المحتلة وبعض الإمارات العربية، ثم صدر في الأردن قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي المحض، وهو أول قانون مدني إسلامي، ثم حذا حذوه قانون المعاملات في الإمارات العربية والسودان واليمن، وكانت جميع هذه القوانين متوجة في أولها بالقواعد الفقهية السابقة، كما اعتمدت هذه القواعد، وهذه القوانين على أنها أوراق عمل أصلية، في مشروع القانون المدني الموحد في إطار الجامعة العربية، ولكنه لم يصدر حتى الآن، كما وُضعت هذه القواعد سابقاً في صدر القانون المدني العراقي.
أما - المملكة العربية السعودية فإنها تعتمد في المعاملات المدنية، والمالية والقضائية على القول المعتمد في المذهب الحنبلي في المحاكم الشرعية، وعلى الأنظمة الخاصة بالمجالات المتعددة الأخرى.
ونضيف لما سبق أربعة أمور ظهرت حديثاً قبل نهاية القرن العشرين وفي مطلع القرن الخاص عر الهجري، وهي: 1 - القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتهاً، لعلي أحمد الندوي، وهي رسالة حصل بها المؤلف على شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي، وهي دراسة قيمة ونافعة ومفيدة عن القواعد الفقهية.
2 - كثر الاهتمام بتحقيق كتب.
القواعد الفقهية، وكتب الأشباه والنظائر في مختلف المذاهب، وتقرر تدريسها في المعاهد الدينية، وكليات الشريعة، والدراسات العليا، ثم اتجهت الأنظار إلى استخراج القواعد الفقهية المبثوثة في كتب الفقه المذهبي، أو كتب الفقه العام، منها رسالة.
(القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية) للطالب سعيد جمعة، في المعهد العالي لأصول الدين بمدينة الجزائر، ونوقشت في أيار (مايو) 1996 م، للحصول على الماجستير، ثم رسالة السيد علي أحمد الندوي، السابق، عن استخراج القواعد الفقهية من كتاب (التحرير) للحصيري في الفقه الحنفي، وحصل بها على شهادة الدكتوراه، ومثل ذلك كثير والحمد لله، ولا تزال الجهود متجهة للعناية بالقواعد الفقهية والاستفادة منها.
3 - مَعْلَمَة القواعد الفقهية: وهو مشروع مهم وكبير يقوم به مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وهو خطوة جبارة وشاملة لجمع القواعد الفقهية من أمهات كتب الفقه الإسلامي في المذاهب الثمانية، مع القواعد الفقهية الموجودة في كتب القواعد.
ويشارك في هذا العمل عدد من العلماء من مختلف البلاد العربية والإسلامية.
وقد كلفت شخصياً باستخراج القواعد الفقهية من كتاب (الأم) للإمام الشافعي، وأنجزت العمل وسلمته في صيف 1996 م، كما تم استخراج القواعد الفقهية من كتاب (المغني) لابن قدامة، و (المبسوط) للسرخسي، وغيرها، ونأمل إنجاز هذا العمل المبارك الخير، لجمع أكبر موسوعة في القواعد الفقهية، ليعود النفع للناس جميعاً، ثم كلفت بمراجعة وتتبع القواعد والضوابط التي استخرجها أحد الباحثين من كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن قيم الجوزية (751 هـ) والتي بلغت 183 قاعدة وضابطاً، وأكملت العمل واستخرجت زيادة عما سبق 163 قاعدة وضابطاً في نهاية سنة 2003 م، مع شرح كل قاعدة، وبيان دليلها وتطبيقاتها والاستثناءات منها.
4 - ظهرت حديثاً عدة كتب في القواعد، وتحرك التأليف والتصنيف في ذلك في مختلف المذاهب، إما للحصول على شهادة علمية كالماجستير والدكتوراه، وإما لمجرد المشاركة في هذا المجال المهم، فمن ذلك: أ - القواعد الفقهية من خلال كتاب (الإشراف) للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، بقلم الدكتور محمد الروقي، أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط - المغرب، ونشرتها دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، في سلسلة الدراسات الفقهية رقم 10، الطبعة الأولى 1424 هـ / 2003 م.
ونال المؤلف بها درجة دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية (الماجستير) عام 1989 م من جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب، وتقع في 458 صفحة.
ب - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي (إيضاح المسالك) للونشريسي، و (شرح المنهج المنتخب) للمنجور، إعداد الأستاذ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغِرياني، ونثرتها دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، في سلسلة الدراسات الأصولية رقم 7، الطبعة الأولى 1423 هـ / 2002 م) وتقع في 567 صفحة، وقسمها الباحث إلى قسمين، الأول: القواعد (132 قاعدة) ، والثاني: الضوابط (14 ضابطا) ، ثم الفهارس، وإن كثيراً من القواعد هي مجرد ضوابط فقهية لباب فقهي خاص.
جـ - القواعد الفقهية، المبادئ - المقومات - المصادر - الدليلية - التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الأستاذ بجامعة الإمام - محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، طبعتها مكتبة الرشد، وشركة الرياض، بالرياض، الطبعة الأولى 1418 هـ / 1998 م، وذلك في سبعة فصول وخاتمة وفهارس في 479 صفحة.
د - القواعد الفقهية الكبرى، وما تفرع عنها، للدكتور صالح بن غانم السدلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ونشرتها دار بلنسية بالرياض، الطبعة الثانية 1420 هـ / 1999 م، ورتب المؤلف القواعد ترتيباً ألفبائياً، وترتيباً موضوعياً تضمن القواعد الكلية الكبرى وما يندرج تحت كل منها من قواعد فرعية، والقواعد الكلية غير الكبرى، ويقع الكتاب في 557 صفحة.
هـ - القواعد الكلية والضوابط الفقهية، تصنيف جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي (909 هـ) تحقيق وتعليق جاسم بن سليمان الفُهيد الدوسري، نشرتها دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 1415 هـ / 1994 م، وتتضمن مقدمة التحقيق (5 - 42) ثم الكتاب (43 - 111) ثم فهرس الموضوعات (113 - 117) وبلغت القواعد مئة، ولكن معظمها ضوابط فقهية.
وأحكام عامة، وعناوين فقهية.
و الفروق الفقهية، للقاضي عبد الوهاب المالكي وعلاقته بفروق الدمشقي، تحقيق ودراسة محمود سلامة الغرياني، نشر دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، سلسلة الدراسات الفقهية رقم 12، الطبعة الأولى 1424 هـ / 2003 م، ويقع في 215 صفحة، وهو بيان للفرق بين كل مسألتين متشابهتين، وموزع على أبواب الفقه.
ز - الفروق، للقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، بعناية جلال القذافي الجهاني، نشر دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء الزاث، دبي، سلسلة الدراسات الفقهية رقم 11، الطبعة الأولى 1424 هـ /2003 م، ويقع في 121 صفحة، وهو الكتاب السابق نفسه، ومقسم على أبواب الفقه.
ح - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 1، 1422 هـ / 2001 م، ويتضمن مئة قاعدة، أكئرها من قواعد مجلة الأحكام العدلية، ويبين الباحث معنى القاعدة.
ثم يعرض أهم الفروع والتطبيقات الفقهية لها، ويقع الكتاب في 232 صفحة.
ط - جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، للدكتور علي أحمد الندوي، ونشرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالرياض - الطبعة الأولى 1421 هـ / 2000 م، في ثلاثة مجلدات، خصص المؤلف الجزء الثالث لفهرس القواعد الفقهية الواردة في القسم الثاني من (الجمهرة) ورتبه حسب جذور المصطلحات والألفاظ الأساسية التي وردت في القواعد.
ي - موسوعة القواعد، تأليف وجمع وترتيب وبيان الشيخ الدكتور محمد صديق بن أحمد البورنو، أبو الحارث الغزي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم - بريدة، بالسعودية، طبع مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الثانية 1418 هـ / 1997 م، ومنهجه ترتيب القواعد ترتيباً ألفبائياً بحسب الحرف الذي تبدأ به القاعدة، ثم شرح القاعدة، ثم الأمثلة لها، وظهر من الموسوعة أربعة مجلدات، الأول في المقدمات وبعض القواعد المبدوءة بحرف الهمزة، والثاني في تتمة القواعد المبدوءة بحرف الهمزة، والثالث والرابع في القواعد المبدوءة بحرف الباء، والتاء، والثاء، وقال الباحث في آخر الجزء الرابع: "ويتلوه قريباً إن شاء الله تعالى القسم الثالث، ويشمل قواعد حروف الجيم، والحاء، والخاء، والدال، والذال، والراء والزاي ".
ك - القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، جمع ودراسة عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، من الإحساء بالسعودية، نشر دار التأصيل - القاهرة، الطبعة الأولى 1422 هـ / 2002 م، مجلدان، يقع الأول في 552 صفحة.
ويقع الثاني في 512 صفحة، وهما للحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأشار في المقدمة لبحث الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان، للحصول على درجة الماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعنوان (القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة) وطبعت من قبل مركز الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى سنة 1416 هـ / 1997 م.
عاشراً: فوائد هذه فوائد أخرى من كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي، ومن غيره، رأينا إثباتها مع تصرف يسير.
الفائدة الأولى: نشأة القواعد الفقهية قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: حكى القاضي أبو سعيد الهروي: أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه، وكان أبو طاهر ضريراً أعمى، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتفَّ الهروي بحصير، وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر المسجد، وسرد من تلك القواعد سبعاً، فحصلت للهروي سعلة، فأحس به أبو طاهر، فضربه، وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه، وتلا عليهم تلك السبع.
قال أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسيناً ذلك ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد: الأولى: اليقين لا يزول بالشك.
الثانية: المشقة تجلب التيسير.
الثالثة: الضرر يزال.
الرابعة: العادة محكمة.
قال بعض المتأخرين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله، نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة تكلف.
وضمَّ بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة، وهي "الأمور بمقاصدها" لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات ".
وقال: (بُني الإسلام على خمس " والفقه على خمس.
قال العلائي: وهو حسن جداً، فقد قال الإمام الشافعي: " يدخل في هذا الحديث ثلث العلم " يعني حديث "إنما الأعمال بالنيات ".
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي (غير تفصيلي) فالخامسة داخلة في الأولى، بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها، ويقال على هذا: واحدة من هؤلاء الخمس كافية، والأشبه أنها الثالثة، وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين، بل على المئتين ".
الفائدة الثانية: طرق وضع القواعد للعلماء في وضع القواعد طريقتان: الأولى: أن يضع القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام من مصادرها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا هو المسمى: بأصول الفقه.
وكان أول من وضع خطة البحث فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فصنف كتابه (الرسالة) وتبعه كل من جاء بعده من علماء المذاهب الأخرى.
الطريقة الثانية: استخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها، فيستنتج أي يستنبط قواعد البيع العامة مثلاً، ويبين مسلك التطبيق عليها، وهي الضوابط، ثم عمم ذلك على مختلف العقود، فصارت قواعد.
الفائدة الثالثه: تاريخ القواعد الفقهية عند الشافعية أول من فتح هذا الباب سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام حيث رجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وألف في ذلك كتابين يدعى أحدهما بالقواعد الصغرى، والآخر بالقواعد الكبرى، كما قاله السيوطي في (الأشباه والنظائر النحوية) .
ثم جاء العلامة بدر الدين محمد الزركشي فتبعه في (القواعد) وألف كتاباً ضمنه القواعد الفقهية، وقبله كان الشيخ صدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل المتوفى سنة 716 هـ رحمه الله تعالى ألف كتاباً في.
(الأشباه والنظائر) تبع فيه ابن عبد السلام.
ثم جاء التاج السبكي فحرر كتاب ابن الوكيل في ذلك بإشارة من والده التقي السبكي، وجمع أقسام الفقه وأنواعه، ولم يجتمع ذلك في كتاب سواه.
ثم جاء العلامة سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 804 هـ) فألف كتاباً في (الأشباه والنظائر) ، والتقطه خفية من كتاب التاج السبكي رحمه الله تعالى.
ثم جاء الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي فنقح جملة من القواعد في كتابه (شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد) ثم عَمد إلى كتاب أوسع يضم جملة من العلوم الفقهية، يقال لمجموعها (الأشباه والنظائر) .
الفائدة الرابعة: المبادئ العشرة لعلم لمقواعد الفقهية ينبغي لكل طالب في أي علم أن يتصوره حتى يكون على بصيرة ما في تطلبه، أو على بصيرة تامة، وذلك بمعرفة مبادئه العشرة التي نظمها العلامة الصبان في قوله: إن مبادي كل فن عشرةْ الحَدُّ والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبةٌ والواضعْ والاسمُ، الاستمدادُ؛ حكمُ الشارعْ مسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا 1 - فحدُّ هذا العلم: قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع.
2 - وموضوعه: القواعد، والفقه من حيث استخراجه من القواعد.
3 - وثمرته: السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت، وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب.
4 - وفضله: أنه أشرف العلوم بعد علم التوحيد، كما شهد به - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " ومعنى ذلك: التفقه في الفروع المحتاج إليها.
وبالقواعد، إذ التفقه في الفروع كلها من لدن بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر الزمان عسير جداً، حيث إن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى، فالمراد إذن التفقه ببعض الفروع، والإحاطة بالقواعد.
5 - ونسبته: أنه نوع من أنواع الفقه، وفرع من علم التوحيد، وبقية العلوم المباينة.
6 - وواضعه: الراسخون في الفروع، إلا أنه كان منتشراً خلال الأسفار (الكتب) وعلى أفواه الرجال، حتى جاء الإمام أبو طاهر الدَّباس، والقاضي حسين، فاعتنيا به، وأشاعاه، وابن عبد السلام فألف فيه.
7 - واسمه: علم القواعد الفقهية، وعلم الأشباه والنظائر.
8 - واستمداده: من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين.
9 - وحكمه: الوجوب الكفائي على أهل كل بلدة، والعيني على من ينتصب للقضاء.
10 - ومسائله: وهي قضاياه أي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار، الفائدة الخامسة: القواعد والضوابط وا، ررارك قال التاج السبكي في (قواعده) : القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا: "اليقين لا يزول بالشك "، ومنها ما يختص، كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ".
والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى: ضابطاً، وإن شئت قلت: ما عمَّ صوراً فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المُدرَك، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر إلى مأخذها فهو الضابط، وإلا فهو القاعدة.
What's Your Reaction?