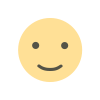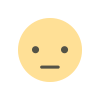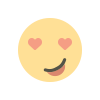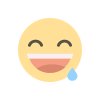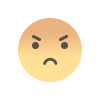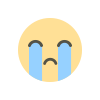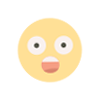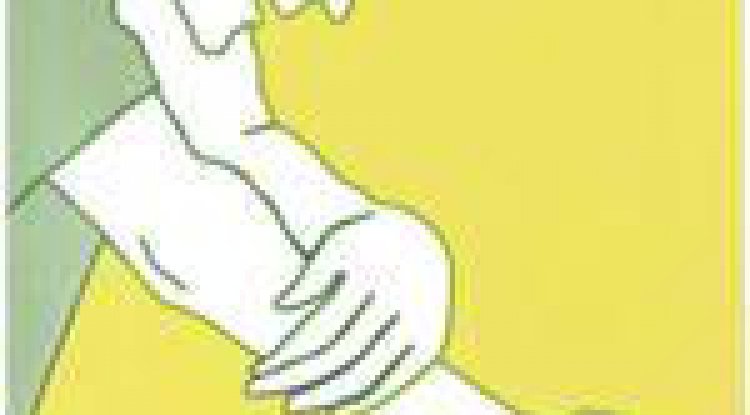القاعدة الأساسية الخامسة العادة مُحَكَّمة
القواعد الفقهية الأساسية

وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود، رضي الله عنه: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح " وهو حديث موقوف حسن، وإنه وإن كان موقوفاً عليه فله حكم المرفوع، لأنه لا مدخل للرأي فيه.
ورواه الإمام أحمد في (كتاب السنة) وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في (الحلية) والبيهقي في (الاعتقاد) عن ابن مسعود أيضاً.
وعقد الإمام البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحاً.
وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحاً، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
وقال تعالى: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ) ، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حماراً، فقال: بكَم؟ قال: بدانقين، فركبه، ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمارَ الحمارَ، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم أي كالأجرة السابقة التي تعارفا عليها) .
وساق البخاري رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في ذلك، وعقب عليها ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: (مقصوده بهذه الترجمة إثباته الاعتماد على العرف، وأنه يُقضى به على ظواهر الألفاظ".
وقال النووي رحمه الله تعالى في فوائد حديث هند رضي الله عنها.
"ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي ".
وحدد ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى الضابط للرجوع إلى العرف والعادة، فقال: وضابطه: كل فعل رُتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يُعدُّ قبضاً، وإيداعاً، وإعطاء، وهدية، وغصباً، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر".
والعادة في اللغة مأخوذة من المعاودة، بمعنى التكرار، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفرس والعقول، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية.
والعادة أيضاً: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وهي المرادة بالعرف العملي.
والمراد بها حينئذ ما لا يكون مغايراً لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم، ولا منكراً في نظرهم، والمراد من كونها عامة: أن تكون مطردة أو غالبة في جميع البلدان.
ومن كونها خاصة: أن تكون كذلك في بعضها، فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة، وهو ما جاء في القاعدة: "إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت" (م/ 41) وقاعدة "العبرةُ للغالب الشائع لا النادر" (م/ 42) .
وإذا لم يرد نص مخالف يشملها فلا كلام في اعتبارها، فقد نقل ابن عابدين أن العادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه، ونقل أيضاً أن البناء على العادة الظاهرة واجب، وهو ما قرره السرخسي والحصيري الحنفيان.
أما إذا ورد فإما أن يكون نصاً في مخالفتها فلا كلام في اعتباره دونها مطلقاً، عامة كانت أم خاصة، لأن النص أقوى من العرف، فالعمل بها حينئذ عبارة عن ردّ النص ورفضه للعادة، وهو لا يجوز، كتعارف الناس الكثير من المحرمات كشرب الخمر، والربا، وسفور المرأة وغيرها.
وإما أن يكون عاماً، ويكون المعتاد جزئياً من جزئياته، وهنا يفرق بين حالتين، إما أن تكون عامة فتصلح أن تكون مخصصة لعمومه اتفاقاً، عملية كانت أم قولية.
وإما أن تكون خاصة، واختلف في أنها هل تصلح مخصصة للنص العام بالنسبة لمن اعتادها أم لا، والمذهب أنها لا تصلح، وعليه مشى أبو بكر البلخي وأبو جعفر الحنفي.
ولكن أفتى كثير من مشايخ الحنفية في بلخ باعتبارها مخصصة بالنسبة لمن اعتادها، وعليه فروع كثيرة أفتوا بجوازها، كشراء الكتاب على شرط أن يَشْرُزَه، والقفل على أن يسمره، أو الفروة على أن يخيط بها الظهارة، أو القبقاب على أن يضع له سَيْراً، أو النعل على أن يُشرِكه، فىِ محل تعارفوا فيه ذلك، وغير ما ذكر مما لا يحصى من الفروع.
وإذا كان الشرع يقتضي الخصوص، واللفظ يقتضي العموم، فالمعتبر الخصوص، فلو أوصى لأقاربه، لا يدخل الوارث اعتباراً لخصوص الشرع، لكن هذا ليس بظاهر، لأنه من قبيل مصادمة العمل للنص المخالف له بخصوصه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث ".
وإنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ.
وعليه فلو كان الوقف سابقاً على ما تعورف من البطالة في الأشهر الثلاثة لا يعتبر ذلك العرف.
وكذلك لو كان التعليق سابقاً على العرف فلا يقيد العرف لفظ التعليق المطلق.
وللعادات والأعراف سلطان على النفوس، وتحكم في العقول، لهذا اعتبرت من ضروريات الحياة، ولهذا قالوا: "العادة طبيعة ثانية" وفي نزع الناس من عاداتهم حرج شديد.
والعرف قسمان: عام، وخاص.
والعرف الخاص: هو ما كان مخصوصاً ببلد، أو مكان دون مكان آخر، أو بين فئة من الناس دون أخرى، كعرف التجار فيما يُعَدّ عيباً، وكعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن البضاعة مقسطاً إلى عدد معلوم من الأقساط، وغير ذلك.
والعرف العام: هو ما كان فاشياً في جيع البلاد بين الناس كالاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم، وكتأجيل جانب من مهور النساء في البلاد الإسلامية، وغير ذلك.
والعرف إن صادم النص من كل الوجوه فهو العرف المردود كما سبق، وإن لم يخالفه من كل وجه كان له تأثير في بناء الأحكام الشرعية عليه، فيترك به القياس، ويخصص به العام كدخول الحمام، والاستصناع، وغيرهما من المسائل الفقهية الكثيرة، ولذلك قال ابن عابدين: والعرف في الشرع له اعتبارُ لذا عليه الحكمُ قد يُدار والقاعدة المذكورة من جملة القواعد الخمس الأساسية، ويتفرع عليها قواعد كثيرة، وإن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعدّ كثرة، وتعسر الإحاطة بها.
التطبيقات 1 - لو بعثه إلى ماشيته، فركب المبعوث دابة الباعث، برئ لو كان بينهما انبساط، وإلا ضمن.
(الزرقا ص 221) .
2 - يجوز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق، على المعتمد، ما لم توجد دلالة المنع.
(الزرقا ص 221) .
3 - اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف كيله أو وزنه، مما لا نص فيه من الأمور الربوية، كالزيتون وغيره، وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند الطرفين.
(الزرقا ص 221) .
4 - اعتبار عرف الحالف أو الناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخص، فلو حلف لا يأكل رأساً، أو لا يركب دابة، أو لا يجلس على بساط، لا يحنث برأس عصفور، ولا بركوب إنسان، ولا بجلوسه على الأرض؛ لأن العرف خص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق، والدابة بما يركب عادة، والبساط بالمنسوج المعروف الذي يفرش ويجلس عليه.
(الزرقا ص 221) (ابن تيمية، الحصين 2/ 131، (ابن رجب 2/ 557) .
5 - أقل الحيض والنفاس والطهر، وغالبها وأكثرها حسب العرف وعادة النساء، (اللحجي ص 45، (ابن عبد الهادي ص 99) .
6 - يجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضئة إذا كانت قليلة، وتحرم الكثيرة، والضابط في القلة والكثرة العادة والعرف.
(اللحجي ص 45) .
7 - الأفعال المنافية للصلاة إذا كانت قليلة فلا تؤثر، وإن كانت كثيرة فتبطلها، والعبرة في ذلك العادة والعرف.
(اللحجي ص 45) .
8 - يُعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة، والعبرة في ذلك العرف والعادة (اللحجي ص 45) .
9 - يجوز البناء في الصلاة في الجمع لفاصل قليل، ويمنع الكثير، وكذا في الخطبة، والجمعة، والعبرة في ذلك العرف والعادة (اللحجي ص 46، (ابن رجب 2/ 409) .
10 - لا يؤثر الفاصل القليل بين الإيجاب والقبول، ويؤثر الكثير، والعبرة للعادة (اللحجي ص 46) .
11 - لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من الحرز، والعبرة في حرز المال العرف والعادة (اللحجي ص 46) .
12 - إن العبرة في ردّ ظرف الهدية وعدمه للعرف والعادة.
(اللحجي ص 46) .
13 - العبرة في الأموال الربوية بالوزن أو الكيل، فيما جهل حاله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يراعى فيه عادة بلد البيع في الأصح.
(اللحجي ص 46) .
14 - لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في صوم مثله، وذلك بحسب العادة.
(اللحجي ص 46) .
15 - يحرم قبول القاضي للهدية، إلا ممن له عادة في إهدائه.
(اللحجي ص 46) .
16 - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق، فالقول قول المرتهن إلى قيمة الرهن عند المالكية، وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الراهن من كل وجه، واستند المالكية إلى قاعدة العرف والعادة، بأن العرف يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه، والعرف جار بأن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف.
(الروقي ص 317) .
17 - إذا اختلف الواهب والموهوب له في الهبة، هل هي للثواب؟.
(للمقابلة والعوض) فادّعى الواهب أنها للثواب، وادّعى الموهوب له أنها ليست للثواب، فيرجع حينئذ للفصل بينهما إلى العرف الجاري عندهم.
(الروقي ص 318) .
18 - اختلاف الزوجين في قبض المهر أو عدم قبضه، فيحسم هذا الخلاف بالرجوع إلى العرف الجاري في بلدهما في هذه المسألة، فإن كان العرف جارياً بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول، ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول، فالقول للزوج احتكاماً للعرف.
(الروقي ص 318) .
19 - الأجرة في دخول الحمام حسب العادة (ابن عبد الهادي ص 99) .
20 - العادة في ركوب سفينة الملاح أنها بأجرة، وكذا العادة في أجرة الدابة (ابن عبد الهادي ص 99) .
21 - هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها، فإن كانت بعد الوفاء فهي جائزة على الأصح، وإن كانت قبل الوفاء لم تجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض.
(ابن عبد الهادي ص 99) .
22 - يلزم حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة (ابن عبد الهادي ص 99) .
23 - الاستصناع؛ أجازه جمهور الفقهاء، لأنه تعارفه الناس، وجرى عليه التعامل فجاز استحساناً مبنياً على العرف.
(السدلان ص 378) .
24 - بيع الوفاء: أجازه التأخرون من الحنفية من باب الاستحسان اعتباراً للعرف ولحاجة الناس إليه فراراً من الربا، ومنعه الجمهور.
(السدلان ص 380) .
25 - هدايا الخطبة التي يقدمها الرجل لخطيبته من الهدايا العينية وغير العينية، المستهلكة وغير المستهلكة، ثم يقع العدول عن الخطبة لسبب ما، فقال بعض الفقهاء في أحكام الهدايا بالرجوع إلى العرف والعادة، فإن كان العدول من الرجل فيمنع من استرداد ما أهداه إليها، وإن كان العدول منها فله حق استرداد ما طدمه إليها إن كان قائماً بعينه، فإن كان مستهلكاً استرد مثله أو قيمته، ويرجع في ذلك إلى العرف، ويتبع عادة الناس ما لم يكن هناك شرط.
(السدلان ص 383) .
26 - جواز وقف المنقول مستقلاً عن العقار إن جرى العرف بوقفه.
(السدلان ص 386) .
27 - الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، كالوضوء، والصلاة، والسفر، والطواف، والأكل، والرضاع، والإخراج من الحرز.
وسيأتي تفصيل ذلك في قاعدة كلية خاصة عند الحنابلة.
(ابن رجب 2/406) .
28 - إن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم، كما أن السؤال والجواب يمضي على ما عمَّ وغلب، لا على ما شذ وندر.
المستثننى 1 - العرف الزائد على اللفظ لا عبرة به، كما لو قال لأجنبية: إن دخلتُ بكِ فأنتِ كذا، فنكحها ودخل بها لا تطلق، وإن كان يراد في العرف من هذا اللفظ دخوله بها عن ملك النكاح؛ لأن هذه زيادة على اللفظ بالعرف، والعرف لا يجعل غير الملفوظ ملفوظاً، فقد قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: "بالعرف يخصّ، ولا يُزاد".
(الزرقا ص 222) .
لكن هذا إذا لم يجعل اللفظ في العرف مجازاً عن معنى آخر، ولم يهجر المعنى الأصلي، فإن هجرت حقيقته، واستعمل في معناه المجازي، كمسألة وضع القدم، ففي مثلها يعتبر المعنى العرفي دون الحقيقي اللفظي.
(الزرقا ص 222) .
2 - الموصي والواقف يحمل كلام كل على لغته وعرفه، وإن خالف لغة الشرع وعرفه، إلا في مسائل استثناها ابن نجيم في (الأشباه) فالعمل فيها على عرف الشرع.
وهي: لو حلف لا يصلي، أو لا يصوم، أو لا ينكح فلانة وهي أجنبية، فإنه لا يحنث إلا بالصلاة والصوم الشرعيين، وفي النكاح بالعقد، وهذا في الحقيقة لا استثناء فيه، فإن العرف فيها موافق للشرع.
(الزرقا ص 222) .
3 - قال الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى: لم يعتبر الشافعي العادة في صورتين: الأولى: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة.
قال الشافعي: إذا لم يجر استئجار لهم لا يستحقون شيئاً.
(اللحجي ص 46) .
الثانية: عدم صحة البيع بالمعاطاة على المنصوص، وإن جرت العادة بعد الشافعي بفعل المعاطاة، وإن كان المختار خلافه في الصورتين.
(اللحجي ص 46) .
فالمعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها، ولو اعتبرت، ولكن النووي قال: المختار الراجح دليلاً الصحة؛ لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره.
ومن أمثلة الحالة الأولى: أن يدفع ثوباً إلى خياط ليخيطه، أو قصار ليقصره، أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه، أو دخل سفينة بإذن، وسار إلى الساحل، فلا يستحقون شيئاً إذا لم يشرط عليه شيئاً من المال، وإن جرت عادتهم بالعمل بالأجرة.
والمختار خلافه كما قاله الشارح رحمه الله تعالى.
(اللحجي ص 46، 50) .
فوائد يتعلق بقاعدة "العادة مُحكَّمة) (م/ 36) عدة مباحث، وهي: المبحث الأول: فيما تثبت به العادة وذلك يختلف، فتارة تثبت بمرة، كما في الاستحاضة، وكما في زنى المبيع وإباقه وسرقته، وكما في العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية.
وتارة تثبت العادة بثلاث كالقائف.
وتارة لا بدَّ من تكرار يغلب على الظن أنه عادة، كالجارحة في الصيد لا بدَّ من تكراره حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم، وكاختبار الديك للأوقات، كما قال الزركشي، وكاختبار حال الصبي قبل البلوغ بالمماكسة في البيع ونحوه، فيختبر حتى يغلب على الظن رشده.
المبحث الثانى في اطراد العادة إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت، فإن اضطربت فلا، وفي ذلك فروع، منها: باع دراهم وأطلق، نزل على النقد الغالب؛ فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان، وإلا يبطل البيع.
ومنها: إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض، أو نوع منه.
انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.
المبحق الثالث في تعارض العرف مع الشرع والمراد بالعرف عرف الاستعمال من الناس لشيء، والمراد بالشرع لفظه، بأنه ورد في الكتاب أو السنة ذلك الشيء فيه، وتعارضهما على نوعين: أحدهما: ألا يتعلق باللفظ الشرعي حكم، فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف لا يأكل لحماً، لم يحنث بالسمك، وإن عاه الله لحماً، أو حلف لا يجلس على بساط، أو تحت سقف، أو في ضوء سراج، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطاً، ولا تحت السماء، وإن سماها الله سقفاً، ولا في الشمس وإن سماها الله سراجاً، أو حلف لا يضع رأسه على وتد، لم يحنث بوضعه على جبل، وإن سماه الله وتداً، أو حلف ألا يأكل ميتة أو دماَ، لم يحنث بالسمك والجراد، والكبد والطحال.
فقد سماها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ميتتان ودمان.
فقدم العرف في جميع ذلك؛ لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف.
النوع الثاني: أن يتعلق به حكم، فيقدم على عرف الاستعمال، فلو حلف لا يصلي، لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود، أو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، أو حلف لا ينكح، حنث بالعقد لا بالوطء، أو قال: إن رأيتِ الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها، وعلمت به طلقت حملاً له على الشرع، فإنها فيه بمعنى العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتموه فصوموا ".
ولو كان اللفظ يقتضي العموم، والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح، فلو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بالميتة، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته، عملاً بخصوص الشرع، إذ "لا وصية لوارث ".
المبحث الرايع في تعارض العرف مع اللغة نقل السيوطي وجهين في المقدَّم منهما: أحدهما: المقدم الحقيقة اللفظية، عملاً بالوضع اللغوي، وإليه ذهب القاضي حسين.
والثاني: المقدم الدلالة العرفية؛ لأن العرف يحكم في التصرفات لا سيما الأيمان، وعليه البغوي، فلو دخل دار صديقه، فقدم إليه طعاماً، فامتنع، فقال: إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم في اليوم الثاني، فقدم إليه ذلك الطعام فأكل، فعلى الأول لا يحنث، وعلى الثاني يحنث.
ونقل عن الرافعي في "الطلاق ": إن تطابق العرف والوضع فذاك، وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع، فإمام الحرمين والغزالي يريان اعتبار العرف، وقال في " الأيمان " ما معناه: إن عمت اللغة قدمت على العرف.
وقال غيره: إن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبتّة فالمعتبرُ اللغة، وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف، وإن هجرت اللغة حتى صارت نسياً منسياً قُدِّم العرف.
ومن الفروع المخرجة على ذلك: ما لو حلف لا يسكن بيتاً، فإن كان بدوياً حنث بالمبني وغيره؛ لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة؛ لأن الكل يسمونه بيتاً، وإن كان من أهل القرى فوجهان، بناءً على الأصل المذكور، فإن اعتبرنا العرف لم يحنث، والأصح الحنث.
ومنها: لو حلف لا يشرب ماء، حنث بالمالح، وإن لم يُعتد شربه، اعتباراً بالإطلاق والاستعمال اللغوي.
ومنها: حلف لا يأكل الخبز، حنث بأكل خبز الأرز، وإن كان من قوم لا يتعارفون ذلك؛ لإطلاق الاسم عليه لغة.
تنبيه أول نقل السيوطي عن الشيخ أبي زيد المروزي (371 هـ) : لا أدري على ماذا بنى الشافعي رحمه الله تعالى مسائل الأيمان، إن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتاً.
قال الرافعي: الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها.
وهو الأصل، وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد.
وقال العزُّ بن عبد السلام: قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة.
تنبيه ثانٍ إنما يتجاذب الوضع اللغوي والعرف في العربي، أما العجمي فيعتبر عرفه قطعاً؛ إذ لا وضع يحمل عليه، فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب، ويدخل في وصية العجم.
المبحث الخامس في تعارض العرف العام والعرف الخاص والضابط: أنه إن كان الخصوص محصوراً لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل من عادة النساء، كيوم دون ليلة، ردَّت إلى الغالب في الأصح، وقيل: تعتبر عادتها، وإن كان الخصوص غير محصور اعتبر، كما لو جرت عادة أهل بلد بحفظ مواشيهم نهاراً، وإرسالها ليلاً، فهل العبرة بالعرف الخاص أم بالغالب؟ الأصح الأول، وينزل ذلك منزلة العرف العام، خلافاً للقفال، ويقال مثل ذلك على حفظ السيارات اليوم بحسب البلدان.
المبحث السادس: العادة المطَّردة هل تنزل العادة المطردة في ناحية منزلة الشرط أم لا؟ وغالب الترجيح في الفروع أنها لا تنزل منزلة الشرط، وفي ذلك صور: 1 - لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؛ الأصح لا.
وقال القفال: نعم.
2 - لو عمَّ في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن، فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؛ قال الجمهور: لا، وقال القفال: نعم.
3 - لو جرت عادة المقترض بردّ زيادة مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط.
فيحرم إقراضه؟! الأصح لا.
4 - لو بارز كافر مسلماً، وشرط الأمان، لم يجز للمسلمين إعانة المسلم، فلو لم يشرط، ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان، فهل هو كالمشروط؛ الأصح نعم، فهذه صورة مستثناة.
5 - ومثلها الأوقات، فإن العادة فيها تنزل منزلة الشرط، كما إذا اعتيد البطالة من المدرسين في الأشهر الثلاثة والأعياد، أو اعتيد الاستنجاء والوضوء من المال المسبل للشرب.
المبحث السابع: العرف المقارن والسابق العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق للتصرف، دون المتأخر، أي أن المعتبر هو العرف المقارن، أي الذي كان موجوداً حال تكلم المتكلم، حتى ينزل كلامه عليه، إذ كان مأخذه سابقاً على وقت اللفظ، دون العرف المتأخر.
ومن الفروع المخرجة على ذلك ما تقدم في مسألة البطالة، فإذا استمر عرفُ وقف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما بعد ذلك، لا ما وقف قبل هذه العادة.
المبحث الثامن: ضبط الأحكام في العرف والشرع قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة؛ يُرْجَع فيه إلى العرف، وذلك كالحرز في السرقة، والتفرق في البيع لخيار المجلس إلى التفرق بالأبدان، والقبض في العقود، وإحياء الموات، والتعريف في اللقطة، والمسافة بين الإمام والمأموم.
وقالوا في الأيمان: إنها تبنى أولاً على اللغة، ثم على العرف، وخَرَّجوا عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف، مع أنها لا ضابط لها في الشرع، ولا في اللغة.
1 - منها المعاطاة: فعلى أصل المذهب لا يصح البيع بها ولو اعتيدت، ولكن النووي قال: المختار الراجح دليلاً الصحة؛ لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره.
2 - ومن أمثلة ذلك: أن يدفع ثوباً إلى خياط ليخيطه، أو قصار ليقصره، أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه، أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل، فلا يستحقون شيئاً إذا لم يشترط عليهم شيئاً من المال، وإن جرت عادتهم بالعمل بالأجرة، والمختار خلافه.
ويتفرع عن هذه القاعدة الخامسة الأساسية عدة قواعد فرعية، وهي القواعد الثلاث عشرة الآتية.
What's Your Reaction?